
مقدمة
صدر عن مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، سنة (2018) كتاب للأستاذ محمد مزوز يحمل عنوان: فلسفة الدين بين التجربة الباطنية والتأمل النظري. ويتكون هذا الكتاب من 197 صفحة من الحجم المتوسط. ويتوزع على ستة فصول مدار الحديث فيها هو النظر في الدين بما هو نظر فلسفي (1). يتخذ كبؤرة له الدين، كما يحيل على ذلك عنوانه، من حيث هو تجربة معاشة جوانيا وباطنيا من طرف المؤمنين، وكذا من حيث هو تجربة تأملية وتنظيرية بالنسبة للمفكرين والفلاسفة عبر التاريخ.
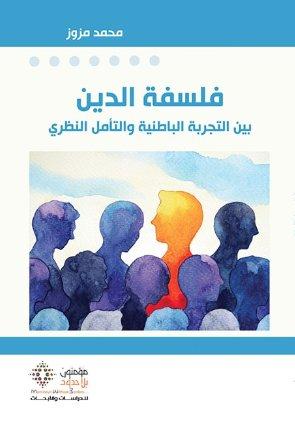
وهناك فرضيتان توجهان كل فصول الكتاب:
· الفرضية الأولى: هناك أوهام متجذرة في ذهنية الكثير من أتباع الديانات، ''وعلى رأسها وهم الهوية، ووهم الأصالة، ووهم أفضلية المعتقد'' (2) وهي أوهام منها يمتح التطرف الذي تعاني منه كل المجتمعات اليوم، والمبشر بفكرة الوحدة، وحدة الحقيقة وحدة العقيدة.
· الفرضية الثانية: إن تجاوز هذه الأوهام، وما يترتب عنها من تطرف، يقتضي الاسترشاد بفلسفة الدين، باعتبارها هي التي توفر تلك الأرضية المحايدة التي يبدو فيها الدين واحدا، والعقيدة عقائد متعددة لكنها متساوية وغير متفاضلة، بل وباعتبارها أيضا فلسفة في التربية تروم تكوين مواطن الغد. مواطن يتمتع بحقه في الاختلاف كحق من حقوق الإنسان. ''مواطن يمارس اعتقاده الخاص دون أن يفكر في فرضه على الغير'' (3).
وفي إطار أجرأته لهاتين الفرضيتين سيعمل صاحب الكتاب على التعريف بفلسفة الدين مع العمل على إعادة بناء مجموعة من العلاقات التي يحيل عليها الدين، والتي يلفها اللبس بشكل يجعلها تغذي الأوهام السالفة الذكر، هي: علاقة الدين بالعقيدة، وعلاقة المعجزة بالإيمان، وعلاقة المقدس بالرهبة والرغبة، علاقة الألوهية بالوجود، وعلاقة التوحيد بالتشبيه والتنزيه.
* فلسفة الدين
يعتبر محمد مزوز فلسفة الدين بأنها فلسفة لها موضوعاتها ومنهجها وغاياتها وقيمتها. وهي رغم كونها قد نشأت في الغرب، فإنها مع ذلك ليست خاصة بهذا الغرب وحده. بل هي مشترك إنساني. ومن هنا فموضوعها لا يقتصر على دين محدد، بل إنه يتسع ليشمل كل الأديان والعقائد، بما في ذلك الديانات والعقائد الطبيعية والوثنية.
وفي إطار دراستها للدين تقوم فلسفة الدين أولا: على فحص البنية الداخلية للدين أي الدين كتجربة باطنية وجوانية وما تقوم عليه من عناصر من قبيل ممارسة الطقوس والشعائر والإيمان بالوحي، والتوحيد، والمعجزة، ووجود الروح، وما تحيل عليه هذه العناصر من شعور الإنسان بوجود قوة عليا وعلة نهائية للعالم الذي يعيش فيه، وما يترتب عن هذا الشعور من زهد في هذا العالم ونزوع نحو معانقة المفارق والمتعالي كعنوان للقداسة. كما تقوم ثانيا :على فحص الدين في بنيته الخارجية، أي في منشئه، وكذلك من حيث هو موضوع للتأويل والتأمل النظري ( كلامي، فلسفي، أنتربولوجي،أركيولوجي، تاريخي... ) ''وثالثا وأخيرا فإن هذه الفلسفة تعمل على المقارنة بين الديانات، وكذا بين الدين، والعلم، والفلسفة، أو الثقافة عموما''(4).
أما على الصعيد المنهجي فإن فلسفة الدين تستند في دراستها لموضوعاتها على منهج نقدي وعقلاني قائم على التفسير والتحليل، وليس على منهج التبرير والتسويغ الذي يستند عليه رجال الدين، وخاصة الغلاة منهم. وبذلك فإنها فلسفة تستوطن المفارقات التي تنخر هذا الدين من الداخل ساعية بذلك إلى ''استنباط المعاني وتفكيك الرموز والكشف عن الأسرار التي يوظفها الدين في حياة الإنسان" (5). ''وبفضل هذه المنهجية يتحرى فيلسوف الدين الاستقلالية والموضوعية في المعالجة" (6). وكذلك ''النأي عن كل نظرة تسطيحية تفاضلية وتطورية للديانات والطقوس الدينية، تنتهي إلى نفي الاختلاف عن مجال الدين، وتكريس نظرة دونية عن هذا الدين أو ذاك من الديانات التوحيدية، وكذا عن الديانات والطقوس والشعائر التي تمارسها العشائر البدائية" (7).
وفيما يخص غاية هذه الفلسفة وقيمتها، فهما تتجليان في كشف النقاب عن أوهام التدين ومواجهتها، وذلك في أفق نزع فتيل التطرف الذي تغذيه هذه الأوهام وينعكس سلبا على أمن واستقرار وتطور المجتمعات، وعلى رأسها المجتمع العربي الإسلامي. ووسيلتها في هذا استثمار المفارقات التي يحيل عليها الدين باعتبارها مدخلا ممتازا، لإعادة بناء هذا الدين، وما يحيل عليه من علاقات واختلافات، على أسس عقلانية بموجبها يضحى فضاء من فضاءات ممارسة الحق في الاختلاف، كحق من حقوق الإنسان الأكثر إلحاحا في عصرنا الحالي.
* علاقة الدين بالعقيدة
تشكل علاقة الدين بالعقيدة إحدى العلاقات التي يكتنفها اللبس وسوء الفهم لدى الكثيرين من المتدينين، في نظر فيلسوف الدين. ويتجلى هذا اللبس في اعتبار العقيدة مرادفة للدين. وتكريس هذا اللبس يشكل إحدى البؤر المغذية للتطرف الديني. لأن باسمه يتم إسقاط خاصية الكونية التي تميز الدين عن العقيدة والتي ''هي مجموعة من التعاليم والطقوس والعبادات والمعاملات التي تخص شعبا معينا" (8). فالعقيدة تتميز بالتعدد والاختلاف بينما الدين يتميز بالكونية. والتعدد والاختلاف في العقيدة مصدرهما اعتبارات تاريخية واجتماعية وسياسية وثقافية وحضارية. ''وهو تعدد واختلاف وإن عملت هذه الاعتبارات على إقصائهما باسم وحدة الدين، إلا أن الحروب الدينية التي سجلها لنا التاريخ قد كشفت عن أن تعدد العقائد أمر واقع، وعن نضال كل عقيدة من أجل حقها في الاختلاف" (9). وهذه العلاقة التنابذية بين الدين والعقيدة لا يدركها إلا فيلسوف الدين كصاحب رؤية شمولية وكملاحظ موضوعي. ويقدم محمد مزوز كنماذج لفلاسفة الدين كلا من ابن طفيل وروسو وكانط. ويرى بأنه مهما اختلف هؤلاء في تصوراتهم الفلسفية لعلاقة الدين بالعقيدة، فإنهم يتفقون على أن الدين كوني وواحد بطبيعته، لأنه يقوم على مجموعة من المبادئ الأخلاقية (الفضيلة العدل الخير...) المتعالية عن المنفعة وما ينتج عنها من صراعات، إنها مبادئ تتوافق مع الوضع البشري، أي مع طبيعة الإنسان كإنسان ينزع بالفطرة نحو الخير والفضيلة... بخلاف العقيدة فإنها ذات طبيعة تاريخية متغيرة ومتعددة ومختلفة، بتعدد وتغير واختلاف المصالح والمنافع والثقافات، كالمسيحية والإسلام، وما يرتبط بهما من مذاهب. وما يجعل من العقيدة منبعا للصراع والعنف والتطرف هو نزوع الغلاة من المؤمنين بها إلى إضفاء إحدى خصائص الدين، أي الكونية، مما يجعلهم يشككون في العقائد الأخرى ويعملون عل إقصائها حتى ولو تفرعت عن نفس العقيدة. ومن الأمثلة على ذلك العقائد المسيحية ( البروتستانية، الكاثوليكية....) فكل عقيدة مسيحية فيها تعتبر نفسها هي الأفضل والأصلح للنوع الإنساني. ومن هنا كان الاصطدام قدرا محتوما على هذه العقائد عبر عن نفسه تاريخيا بالحروب الدينية التي عرفها العالم الأوروبي في القرن السادس عشر بين الكاثوليك والبروتستانت.
* علاقة المعجزة بالإيمان
إن توقف فلسفة الدين عند علاقة المعجزة بالإيمان يهدف إلى رصد المفارقات والإحراجات التي تكتنف هذه العلاقة والتي تقتضي تجاوزها، وذلك في أفق تطهير الإيمان أو الدين، كما يقول برديائيف، ''من تلك العناصر المكونة للمعرفة الساذجة التي تختلط بالدين وتؤثر عليه سلبا" (10). بحيث باسم هذه المعجزة تنتهي إلى إساءة فهم الدين وجعله عنوانا للحقيقة المطلقة والمتعالية، مما يمكن أن يشكل منبعا للغلو والتطرف والإساءة للإيمان نتيجة لذلك.
فإذا كانت المعجزة، كما يتصورها رجل الدين هي خرق للعادة، هي إبطال أو إلغاء لنظام الطبيعة وما يقوم عليه من سببية، ولو لفترة محدودة. فهي بهذا تثير الإعجاب والاندهاش بحيث تتخذ عنوانا لتدخل الله في نظام العالم وخرقه. إنها بمثابة حجة لمواجهة المتشككين في الدين، ولتقوية لعزيمة المؤمن وترسيخ إيمانه. لكن فيلسوف الدين يطرح بهذا الصدد مجموعة من الأسئلة من بينها السؤالين التاليين: إذا كانت المعجزة فعلا إلهيا في ظواهر الكون يخرق النظام الذي وضعه فيها بنفسه، فهذا تناقض، وإلا كيف يمكن أن نقبل أن الله هو فاعل النظام في الكون وهو الذي يخرق هذا النظام من خلال المعجزة؟ أفلا يجعل القول بالمعجزة هنا يوحي لنا بوجود إلهين: ''أحدهما يزرع النظام في الكون والآخر يستأصله، أو على الأقل يوقف العمل به إلى حين؟" (11).
إن طرح هذين السؤالين من شأنه أن يكشف عن اختلاف التناول الديني لقضايا الوجود والحقيقة والألوهية، عن التناول الفلسفي لنفس القضايا كتناول يتوصل من خلاله فيلسوف الدين إلى أنه يجوز النظر إلى المعجزة بوصفها ''عائقا أونطولوجيا '' ''لا يقف فقط أمام سيرورة الظواهر الطبيعية وانتظامها وتناغمها" (12). بل وأمام الطريق الصحيح للإيمان أيضا. وهذا ما يؤكده، حسب صاحب الكتاب، مجموعة من الفلاسفة أمثال: ابن رشد، وسبينوزا، وبول ريكور... فسبينوزا مثلا ''يرى بأن الإيمان بالمعجزات لا يفضي إلى الإيمان بالله بل يفضي إلى إنكار وجوده. إذ بما أن المعجزة تخرج عن النظام السائد في الطبيعة وتخرقه، فهي تتجاوز حدود الفهم البشري. وما يتجاوز فهمنا فنحن نجهله، لذلك يستحيل أن تكون المعجزة طريقا إلى الله" (13).
وفيما يخص ابن رشد فهو بدوره يرى بأن القول بالمعجزة، بما هي خروج عن نظام الطبيعة، من شأنه أن يؤدي إلى إلغاء مبدأ السببية المتحكم في الطبيعة والقول ب ''الجواز''. و'' من أنكر وجود المسببات مرتبة على الأسباب في الأمور الصناعية أو لم يدركها فهمه فليس عنده علم بالصناعة ولا الصانع كذلك من جحد وجود ترتيب المسببات عن الأسباب في هذا العالم فقد جحد الصانع الحكيم تعالى عن ذلك علوا كبيرا" (14) أما بول ريكور فإنه يرى أننا '' لكي نفهم يجب أن نؤمن، ولكي نؤمن يجب أن نفهم '' و هذا الفهم يقتضي الاعتقاد بما يعلنه النص الديني وما يوظفه من رموز وعلامات قصد تقريبها إلى عالم الإنسان، وذلك في أفق منح الدلالة لعالم الكائنات والحصول على وفرة المعاني وتعددها. ففهم النص الديني إذن يتحقق، حسب ريكور، من خلال توليد المعاني الكامنة فيه وتفصيلها على مقاس العقل البشري. ''وهذا ما يرفع عن هذا النص غلافه الأسطوري الذي تضفيه عليه المعجزة، والذي يجعل هذا النص أحادي المعنى ومطلق الحقيقة"(15).
* المقدس وعلاقته بالرغبة والرهبة
عندما يقف بنا صاحب الكتاب عند مفهوم المقدس بين الرغبة والرهبة، فهو بذلك إنما يروم تفكيكه كأحد الرموز الملازمة لكل دين. وهو تفكيك عندما يحيلنا على مفارقة الرغبة والرغبة إنما يروم تقديم تفسير أنتربولوجي عقلاني لهذا المقدس بموجبه يكشف عن ارتباطه بحياة الإنسان وبتاريخه وما يلفهما من تقلب واختلاف وتغير وآمال وآلام، وذلك في أفق إزالة الغطاء الأسطوري عن هذا المقدس ونفي طابعه المتعالي، واللذان غالبا ما يستغلان في الدفاع عن تفاضل العقائد وتكريس الصراع فيما بينها، وما يؤدي إليه من تطرف وممارسة للعنف. وقد استند محمد مزوز في هذا التفكيك للمقدس على مجموعة من الباحثين الأنتربولوجين من قبيل روجي كايو، وميرسيا إلياد، وروني جرار، وفرويد... والذين مهما اختلفوا في زوايا النظر للمقدس فإنهم يتقاطعون في القول أولا: إن المقدس لا يختص به دين دون أخر، فهو مشترك إنساني ضارب في القدم لذلك لا مجال للتفاضل بين هذه الأديان حوله. كما يتقاطعون في القول ثانيا: بأن المقدس مهما بدا إلهيا ومفارقا وروحانيا، فهو في جوهره من صنع الإنسان وتاريخه، إذ يعمل على تجسيده في المكان والزمان كما يقول كايو.
فتجلي المقدس في المكان يعبر عن نفسه بالنسبة للديانات القديمة في تقديسها للأحجار أو الأشجار. أما بالنسبة للديانات التوحيدية كالإسلام والمسيحية واليهودية، فالمقدس يتجلى في الكلمة والحرف ( الكتاب المقدس) أو في شخص النبي أو الرسول. ''كما يتجلى مثلا في أماكن الحج لدى المسلمين أو الهيكل لدى اليهود" (16). ''كما يتجلى المقدس في ممارسة طقوس التضحية،كممارسة اجتماعية تتغيا درأ الثأر أو العنف من المجتمع وجلب الخيرات والأمن، كما يرى مثلا روني جرار" (17). فيما يتعلق بتمظهر المقدس في الزمان لدى الإنسان المتدين، فيتجلى في كون هذا الأخير، حسب روجيه كايو، يعيش نوعين من الزمان: الزمن المقدس والزمن الدنيوي. ''الأول دائري يمكن استعادته باستمرار على شكل دوري من خلال طقوس الأعياد والحفلات الدينية، أما الزمن الثاني، أي الدنيوي، فهو زمن متصل له بداية وله نهاية ولا يمكن استعادته" (18).
* الألوهية وعلاقتها بالوجود
إن طرح سؤال الألوهية في علاقتها بالوجود يتغيا في هذا الكتاب الوقوف عند تشكيك الفلاسفة والمتصوفة في اقتران مفهوم الألوهية بمفهوم الوجود. وهو تشكيك ناتج، حسب محمد مزوز، عن ذلك الفقر اللغوي في ثقافة كل من الديانتين اليهودية والإسلام، ممثلا في غياب فعل الوجود واسم الوجود فيهما. ''هذا الفقر الذي سيتولد عنه ذلك التوتر التاريخي حول مفهوم التوحيد في هاتين الديانتين بين التنزيه والتشبيه؟" (19). وبموجب هذا التوتر سنجد الفلاسفة والمتصوفة يعارضون علماء الكلام المسلمين في دفاعهم عن انتساب الله للوجود في صورته الذهنية المجردة، والتي من شأنها أن تبعده عن خطر التشبيه الذي كانت تدافع عنه الديانات الوثنية. فهو انتساب لا يساعد على النفاذ إلى حقيقة الله وجوهره في نظرهم. ''من هنا سيرى المتصوفة كالحلاج وابن عربي..، وبعض الفلاسفة، مثل ماريون وبرغسون" (20) بأن الله جوهر لا يمكن النفاذ إليه من بوابة الوجود، بل من بوابة الحب. هذا مع اختلاف هؤلاء في ما إذا كان هذا الحب يجافي التفكير العقلي في الله، كما هو الحال بالنسبة للمتصوفة وماريون...أم العكس كما يرى برغسون...؟ وهكذا يري ماريون مثلا استحالة احتلال الله لحيز معين في الوجود. ''فالوجود، كما يقول، لا يتسع للإله ولا يسعه فهو أكبر من كل شيء حتى الوجود ذاته" (21). وأن ينظر إلى الحب كمدخل للتفكير في الله وإدراك جوهره، فذلك يشكل رسالة واضحة لأنصار الغلو في الدين والمبشرين بالعنف والكراهية باسم الدين.
* التوحيد يتقلب بين التنزيه والتشبيه
إن التفكير في التوحيد كمفهوم مركزي في الديانات التوحيدية هو تفكير انتهى إلى الانتقال بهذا التوحيد من كونه مفهوما مسلما بدلالته القائمة على ربط هذا التوحيد بالتنزيه، إلى كونه إشكالية فلسفية بموجبها سيشكك الباحثون في هذه الدلالة باعتبارها لا تخلو من مفارقة قوامها تقلب هذا التوحيد بين التنزيه والتشبيه.
وهكذا وبالاستناد على ما توصل إليه الأركيولوجيون والمؤرخون وعلماء النفس واللغة... فإن تاريخ التوحيد لا يبدأ مع الديانة اليهودية كأقدم ديانة توحيدية، بل يضرب بجذوره في الأعماق السحيقة للوعي البشري لأن تاريخه كما يشير إلى ذلك الباحث الأنتربولوجي، ج. سميت لا يرجع إلى هذه الديانة اليهودية، بل إلى ما قبلها. وهذا ما يكشف عنه في نظره، ما ورد في اللوح الحادي عشر والأخير من ملحمة جلجماش في نسختها التي تعود إلى الألفية الثانية قبل الميلاد. بحيث تبين أن الثوراة لم تكن مملاة من طرف الله كما يدعي اليهود، بل هي حصيلة تراث إنساني سابق. فهي قد اكتفت باستعادة رواية أحداث هذا الماضي، التي لعب فيها النبيان إبراهيم وموسى دورا أساسيا، بأسلوب رمزي يتداخل فيه الواقع بالخيال. فهذان النبيان إبراهيم باعتبارهما يمثلان، فكرة التوحيد في نسختها التوراثية أولا والمسيحية ثانيا والإسلامية ثالثا، هما شخصيتان، بحكم تأكيد الباحثين على انتمائهما الفرعوني أو المصري، فإنهما تشكلان من الناحية التاريخية عنوانا لتلك المثاقفة التي حصلت بين التعاليم التوراثية والثقافة المصرية كوريثة للثقافات السابقة عليها (البابلية والآشورية). إنها مثاقفة من بين مظاهرها كما يقول الباحثان: الأخوان صباح، كون ''صفات الله العشرة لدى اليهود ممثلة في'' العلو والحكمة والذكاء والرحمة والقوة والجمال والنصر والمجد والأساس والملك (....) كانت مدرجة أصلا بوصفها صفات الفراعنة" (22) ''وبهذا الاكتشاف لم تفقد الثوراة وحدها امتيازها في تأسيس فكرة التوحيد الإبراهيمية بل فقدت معها الديانات التوحيدية الأخرى" (23). ''كما أن بهذا الاكتشاف سيصبح التوحيد مسكونا بالتعدد بحيث لم يعد له معنى واحدا ووحيدا هو التنزيه بل أصبح أيضا عنوانا للتشبيه بما هو انفتاح على عالم الإنسان المتعدد والمختلف كموطن للألوهية عند الفراعنة، والذين ابتدأ معهم هذا التأرجح بين التشبيه والتنزيه" (24). وهذا ما يكشف تفاعل هذه الديانات التوحيدية مع أحداث التاريخ وصراع الثقافات والحضارات.
خاتمة
نخلص مما سبق ''إذن إلى أننا أمام كتاب له فعلا راهنيته، وخاصة بالنسبة للمجتمعات الإسلامية، كما يوحي بذلك صاحبه في مقدمته" (25). فهو كتاب جاء في وقته المناسب، ليقدم لهذه المجتمعات مجموعة من الدروس حول الدين، انطلاق من هذا الدين نفسه، دروس تستنبط منها مجموعة من العبر على رأسها، أن الانكفاء على الذات وعلى الماضي ومعاداة مالا يشارك هذه المجتمعات عقيدتها التي تنظر إليها وكأنها عنوان الحقيقة المطلقة، وحبل النجاة الأبدي من التخلف، هو مجرد وهم ومؤشر على انحراف مزدوج قوامه، إما الانغلاق على الذات وكراهية الآخر، وإما الارتماء في حضن الآخر وما يترتب عنه من اغتراب وتبعية. وفي الحالتين معا ستزيد هذه المجتمعات بعدا عن تحقيق حداثتها. وبتعبير آخر فإن أكبر درس وأعظم عبرة يقدمها لنا هذا الكتاب هو التبشير بأكثر الحقوق الإنسانية إلحاحا اليوم هو ''الحق في الاختلاف'' الذي بشرت به الحداثة منذ نشأتها في أكثر الحقول رفضا لهذا الاختلاف هو الحقل الديني المهيمن عليه من المتطرفين. لهذا فإنه كتاب عندما يبحر بنا في دروب التاريخ، وفي مفاصل الاعتقادات ورموز لغة الدين وطقوسه، فإن هاجسه في كل هذا هو تفكيك تلك النواة الصلبة التي انطلاقا منها يتغذى الغلو والتطرف في الدين، ألا وهي ''الوحدة'' كمفهوم يستقي دلالته، كما يقول عبد الكبير الخطيبي، من مفهوم ''التوحيد'' كما يفهمه الغلاة، أي من حيث أنه يقوم في جوهره على الحقيقة الواحدة والمطلقة والمتعالية عن أحداث التاريخ، والتي يحتكرها دين ما. وهكذا وبموجب هذا التفكيك لمفهوم ''الوحدة'' في مختلف مظاهرها الدينية، أصبحت هذه الأخيرة في هذا الكتاب مسكونة بالاختلاف والمفارقات، كما أصبح الدين، ومهما توغل في سماء ميتافيزيقا الروح، خطابا حول وجود الإنسان بآماله وآلامه، الاجتماعية والسياسية والروحية. ومن هنا كان هذا الدين في ماهيته، التي يكشف عنها التاريخ، عنوانا لممارسة الحق في الاختلاف وعدم احتكار السلطة. ''وهذا ما تبشر به العلمانية في صورتها المعاصرة والتي لم يعد فيها الدين سلطة مطلقة بل أضحى سلطة من بين السلطات السائدة في المجتمع المشاركة بعدل في تدبير الشأن السياسي كما يقول ناصيف نصار" (26). هذه العلمانية التي حبذا لو أن صاحب الكتاب قد أفرد لها فصلا خاصا، ليكشف من خلاله عن ذلك الدور الممكن للدين في ظل المجتمع الليبرالي الديموقراطي المعاصر.
[1] - محمد مزوز، فلسفة الدين بين التجربة الباطنية والتأمل النظري، مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، الطبعة الأولى، 2018، ص. 10.
[2] - فلسفة الدين، ص. 11.
[3] - نفسه، ص. 12.
[4] - فلسفة الدين، ص. 36.
[5] - نفسه، ص. 179.
[6] - نفسه، ص. 36.
[7] - نفسه، ص. 35. [7]
[8] - فلسفة الدين، ص. 37.
[9] - نفسه، ص. ص. 37/38.
[10] - فلسفة الدين، ص. 88.
[11] - نفسه، ص. 63.
[12] - نفسه، ص. ص. 63/64.
[13] - نفسه، ص. ص. 65/66.
[14] - ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1998 (ص. 166/167).
[15] - فلسفة الدين، م س، (ص. 81/82).
[16] - فلسفة الدين، ص. 92.
[17] - فلسفة الدين، ص. 105.
[18] - نفسه، ص. 96.
[19] - نفسه، ص. 140.
[20] - نفسه، ص. ص. 118/119.
[21] - فلسفة الدين، ص. 122.
[22] - فلسفة الدين، ص. 148.
[23] - نفسه، ص. 142.
[24] - نفسه، ص. 176.
[25] - يتجلى هذا الإيحاء في استعمال الكاتب لنون الجماعة ككناية عن المجتمعات الإسلامية.
[26] - أنظر بهذا الصدد الفصل الأخير من كتاب ناصيف نصار: الإشارات والمسالك، دار الطليعة، بيروت، الطبعة الأولى، ( 2011).



